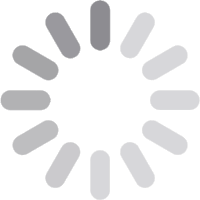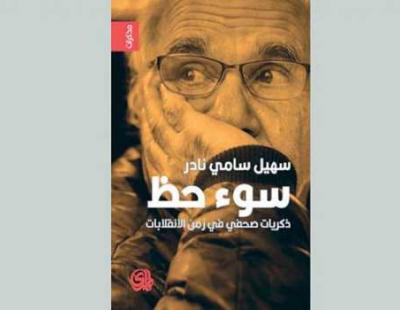«سوء حظ»... تاريخ موجز لسيرة خاسر وموت دولة
«سوء حظ»... تاريخ موجز لسيرة خاسر وموت دولة
ليس سوى «سوء حظ»... هكذا ببساطة جارحة يكتب لنا سهيل سامي نادر ذكرياته عن عمله الصحافي في زمن الانقلابات. «سوء حظ»؛ كلمتان نكرتان يتصل بعضهما ببعض لتؤلفا عنواناً مشبعاً بالألم والسخرية والكوميديا السوداء. وهما معاً الصيغة الصادمة التي يجري عبرها اختصار نصف قرن من العذاب الشخصي للكاتب، وهو ذاته بعض تاريخ الصحافة في العراق، وتاريخ العراق في زمن الانقلابات، زمن المحن المتوالدة. فهل كان الأمر مجرد «سوء حظ» لازم واحداً من أبرع صحافيي العراق وأكثرهم مهارة وكفاءة وحظاً سيئاً؟ هل حقاً أن مصائر الناس والبلاد تصنعها الأقدار السيئة والحظوظ المتدنية في بلادنا سيئة الحظ؟
ثلاث قضايا كبرى تعلَّق بها كتاب «سوء حظ... ذكريات صحافي في زمن الانقلابات: المدى، بغداد، 2020»، ولقد تحكمت بالكتاب السيري، فكان تأكيداً لها وترديداً لبراهينها. هذه القضايا عبرت عنها مقدمة الكتاب بصراحة ووضوح كافيين؛ فهي المفاتيح الممهِّدة لعالم الكتاب. أولها مقصده من تركيبة «سوء حظ»، وهي لا تحيل، هنا، إلى مجرد تاريخ شخص مفرد عاش وعمل في إطار زمني محدد؛ إنها تربط «وللدقة علينا، ربما، أن نكتب تعجن!» مصائر أجيال عراقية كثيرة بصفة «سوء حظ» في سياق تاريخ عراقي محدد، إنه ما بعد انقلاب فبراير (شباط) عام 1963، ذلك الحدث الرهيب الذي جعل الكاتب وأقرانه ومن جاء بعدهم «مجرد شريك بسوء حظ ضم أجيالاً من العراقيين فقدوا الأمان وتحولت حياتهم إلى جحيم». نحن هنا إزاء «سوء حظ» وطني يشمل بلاداً كاملة في سياق تاريخي متصل ومعلن. يبدأ الحظ السيئ، شخصياً ووطنياً، بانقلاب فبراير عام 1963. ولا بأس، لكن لماذا يبدأ الكاتب بهذا الانقلاب؛ ألم يعنون الكتاب بقوله: «ذكريات صحافي في زمن الانقلابات»؛ أليس ما حدث قبل مذبحة فبراير هو انقلاب أيضاً، ألم يسمِ الكاتب نفسه ما حدث عام 1958 انقلاباً، ونص على هذه الكلمة في كتابه هذا وفي مقالات سابقة أثارت غضب جماعات سياسية محدَّدة؟ ليس لدي تفسير لما حدث سوى أمر واحد. يتعلَّق بحداثة عهد سهيل سامي نادر، شبابه المبكر بالنسبة لحدث يوليو (تموز) عام 1958، فسهيل المولود في البصرة عام 1943 لعائلة عراقية معروفة بانحيازها اليساري؛ أبوه سامي نادر، مثلاً، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي، لم يزد عمره، آنذاك، على خمسة عشر عاماً. ماذا يعني هذا؟ لا شيء؛ فسهيل نفسه قد كتب مراراً أن ما حدث عام 1958 هو تمرين أولي على الحياة، وهو مختلف كلياً عن انقلاب فبراير الرهيب الذي دشن الصياغات الكبرى لتأميم الحياة والأمل والخطاب بمستوياته المختلفة في العراق. لكن «سوء حظ» يلتقي هنا، عميقاً، مع السياق المقاوم للقبح وتدمير الحياة السوية في العراق. إنه بعض ما يسميه الكاتب نفسه «تحويل سوء الحظ إلى ضرب من المزاح والمرح»، وهو عندي السبيل المتاحة، الوحيدة ربما، لمقاومة اليأس والخذلان بالضحك والسخرية. في فصول الكتاب، بالضبط، في اللحظات التي نجد فيها سهيل يكتب عن سيرته تحضر السخرية والنكتة المفارقة في لجة الخوف والكراهية المضادة.
وهناك ما يسميه صاحب رواية التل «سيطرة الأزمان القصيرة» التي تبدو لنا صياغة مختلفة لموت الذاكرة عند العراقيين. نعم، لم يكن سهيل سامي نادر في وارد مناقشة قضية الذاكرة والتذكر في سياق كتابه، هذا شأن آخر لا يتصل ربما بجوهر سيرته المتأثرة بفعل السلطة الضاغط عليه وعلى غيره ولا شك، لكن سيرة الذاكرة وموتها في عقول ومخيال الناس حاضرة، بقوة، ونحن نقرأ ونشاهد فعل السلطة المخرب لكيان الدولة. وإن شئتم يمكننا أن نتحدث عن سيرة موجزة لموت الدولة في العراق برواية سهيل سامي نادر. هل نحن نقوِّل الكاتب ما لم يقله؟ لا أعتقد، فقصر الزمن شاهد ودليل على موت الذاكرة الجمعية في مجتمع ما. تحضر قسوة النسيان المفروض على الناس عبر ما يسميه الكاتب «تراكم المشاكل» بدلاً من تراكم الخبرة. وهو فعل السلطة التي تنتقي أدواتها المخربة، وفي الطليعة منها تدمير ذاكرة المؤسسات بزعم تشييد ذاكرة جديدة. يكتب نادر أن لا أحد يبقى في مكانه طويلاً «يُستبدل الأشخاص عن طريق الغضب أو الترقيات، ويختفي أشخاص عن طريق السجن أو القتل أو الهجرة، وتفسد المؤسسات بألوان من التدخلات السياسية والفكرية والمزاجية». وهذا أسوأ أنواع ألزهايمر الوطني المضاد لفعل الذاكرة. في زمن الانقلابات لا ذاكرة للدولة وشعبها سوى ما يريده القائمون على السلطة.
القضية الثالثة الرئيسية أننا في سياق كتاب ينهمك بكتابة سيرة مهنية دامت خمسين عاماً، وما زالت مستمرة، ولسنا، من ثمَّ، بصدد سيرة ذاتية «شخصية». هل هناك فارق بينهما؟ سهيل سامي نادر نفسه يقول لنا في مقدمته إن محنته في هذا الكتاب انحصرت في عدم التوسع بأمرين: حياته الشخصية والسياسة. لكن متن السياسة توسع كثيراً لأنه جزء أصيل، أو هكذا هو في عراق الانقلابات، فصارت السيرة المهنية بعضاً من مشكلة السلطة في العراق. يسمي الكاتب سيرته «ذكريات»، وهذه الكلمة تضعنا أمام مقدار لا بأس به من الذاتية المتصلة بسيرة الكاتب الشخصية. نتأمل العنوان مجدداً؛ إنه يتحدث عن ذكريات صحافي في زمن الانقلابات، ثمة هنا هامش شخصي يتحرك بموازاة السيرة المهنية، وكلاهما يتشكَّل في إطار زمن سياسي مضطرب. هامش السيرة الشخصية للكاتب يحضر في تفاصيل وفصول متن السيرة، مع حرص كبير على ألا تتحول حياة الكاتب الشخصية إلى مأثرة كبرى، أو كما كتب في رسالة شخصية: «أنا حذر من أن أمنح حياتي قيمة كبيرة». وبتصوري أن هذه القيمة حاصلة لا محالة؛ في الأقل إنها إحدى صياغات الخطاب المضمرة، نجدها في منطق الخاسر سيئ الحظ، صاحب القصة. كذلك في منطق المقاومة الساخرة، في تذكير القارئ المستمر أن ثمة حظاً سيئاً يطارد الكاتب؛ في الخشية من ورطة الكتابة، وفي التشديد على منطق البريء، مصحح الأخطاء.
لا يحيد سهيل سامي نادر عن هذه القضايا الثلاث الرئيسية في فصول وفقرات الكتاب كلها. وعندي أنها المبادئ التي انتظمت وصاغت الكتاب. ولها الفضل كله في تمكين الكاتب من الظفر باللحظات الكبرى في سيرته المهنية، وهي ذاتها، ربما بتصرف، هوامش السيرة الذاتية، مثلما هي المفاصل الكبرى للتاريخ السياسي للعراق. كان منطق الخاسر، سيئ الحظ، مثلاً، وراء اكتشاف مأثرة الستينيين المنسية، إنها في مكان آخر، بعيداً عن الصخب والجدالات الشعرية الكبرى حول البيان الشعري وجماعة كركوك. يعود بنا الكاتب إلى قلب بغداد، بالضبط إلى ساحة التحرير، حيث نصب الحرية الذي دشن الستينات العراقية؛ هنا القصة كلها، فيما جرى نسيانه، إنها مأثرة الفنانين التشكيليين العراقيين التي جرى إهمالها لحساب المنجز الستيني في الشعر والرواية والقصة القصيرة. وأحسب أن الخاسر هو وحده القادر على اكتشاف المهمل الثمين؛ لأنه بعض خسارته. فقد تحول شعر الستينات العراقية إلى محض ظواهر شعرية مهمة ولا شك، فيما ظل الفن حاضراً في الذاكرة والوجدان. ولا رهان على خيارات الناس؛ عندما جعلوا من نصب الحرية مكاناً للتنديد والتظاهر ضد السلطة الفاسدة المخربة. لا رهان أبداً، إنما هو بعض مأثرة الفنان الستيني المنسي والمهمل، وهو صنيعه في ذاكرة الأجيال اللاحقة.
ومثلها، بالضبط، قصة موت الذاكرة في زمن تأميم الحياة والخطاب، وهو ما يسميه سهيل سامي «سلطة الأزمان القصيرة»، كما أشرنا سابقاً، فإنها تظهر بصفة الحاكم والمتحكم في متن السيرة المهنية، شأن السيرة الذاتية، فلا طموحات كبيرة، ولكن لا خيبات مدمرة أيضاً. يعرف الخاسر أن لا أمل يُرجى من الكتابة؛ فهي التي ستراكم الحظ العاثر، تستجلبه من كل حدب وصوب حتى لو كان في جزر الواق واق. لكن نادر العارف بطبيعة السلطة في بلاده سمح لنفسه بأن يكتب بدراية ومعرفة وتبصر يُحسد عليها. هل كان الحسد نوعاً من سوء الحظ؟ ربما...
في «سوء حظ» يجهد مصحِّح الأخطاء، كما وصف نفسه في الكتاب بلا قصد وفي سياق محدَّد، أن يتوخى أقصى درجات الموضوعية في كتابة سيرته المهنية؛ فهو يعرف أن كتابة سيرة الذات ورطة لا أصعب منها، وهو يعرف كذلك أنه فخ لا بد منه. فكيف ستكون الحال عندما نكتب عن ذات فاعلة ومبدعة في سياق عراقي ملتبس وعصيب؟ «سوء حظ» إضافة مهمة في النقاش حول الخطاب الثقافي العراقي في عهود ما بعد فبراير 1963 ويتصل بزمن الديكتاتور والاحتلال. وعندي أن الكتاب يضيء مناطق معتمة كان الكاتب قد عاش تفاصيلها وكتب عنها بمنطق العارف الأمين المصحِّح للأخطاء، لا سيّما في حالة العراق الذي أُحرقت مكتباته وسجلاته ووثائقه، فصار تاريخه الثقافي مشاعاً للمدَّعين. «سوء حظ» تاريخ موجز لسيرة الخاسر، سيئ الحظ، لكنه كذلك تاريخ موجز للبلاد سيئة الحظ.
المصدر:الشرق الأوسط.